مباركة، أرملة خمسينية من سيدي بوزيد، تستيقظ كل صباح قبل الفجر لتخبز بعض الأرغفة لأطفالها، ثم تمضي إلى حقل الزيتون حيث تعمل طيلة نهارها مقابل بضع دنانير. لا تعرف مباركة اسم وزيرة المرأة، ولم تسمع يومًا عن "المساواة في الميراث"، ولا تفقه معنى "التمكين الاقتصادي". كل ما تعرفه أنها امرأة يجب أن تعمل وتكدّ لتأمين لقمة عيش صغارها.
في الجهة الأخرى من البلاد، وفي أحد نزل العاصمة الفاخرة تجتمع مجموعة من الناشطات المثقّفات، اللاتي يتبادلن التقارير حول حقوق النساء في العمل والمساواة والحقّ في الجسد، وهو نشاط تحضره العديد من الصحفيات والصحفيين، ويُفتتح عادة بفطور صباحي ويُختتم بغداء جماعي، لينتهي بإصدار بيان يُندّدن فيه بواقع المرأة التونسية ولا سيّما المرأة الفلاحة، ويُطالبن الحكومة بسنّ مزيد من القوانين لحمايتها.
لكن هل تعكس هذه الاجتماعات واقع النساء فعلًا؟ وهل الصوت الذي يعلو فيها هو الصوت الذي ينبغي أن يُسمع؟
في الحقيقة معاناة مباركة ليست مجرد تفصيلة هامشية، بل هي الأساس الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان عند الحديث عن النضال النسوي. مباركة لا تمثّل صورة المرأة "المثالية" التي يعاد تدويرها في المؤتمرات، ولا تعنيها الشعارات عن المساواة أو الحقوق القانونية التي تبدو بعيدة كل البعد عن واقعها المعيشي. إنها غائبة عن هذه النقاشات، وإن حضرت فوجودها غالبًا رمزي، لن تتجاوز كلمتها في أفضل الحالات بعض العبارات التي تزيّن الجلسات لكنها لا تمسّ الجوهر.
تقول مباركة: "أنا لا أحتاج حزمة من القوانين التي بقي أغلبها حبيسة الرفوف، بل بحاجة إلى حلول عملية تحدّ من معاناتي اليومية، فالقوانين التي تكفل المساواة في الميراث أو المشاركة في الحياة السياسية لا تعني شيئًا لامرأة تعمل في الأرض 12 ساعة في اليوم براتب زهيد، ولا تحصل على أي ضمانات اجتماعية."
هذا التباين ليس صدفة، بل نتيجة خطاب نسوي بقي طويلًا حبيس المركز، يتحدّث باسم جميع النساء دون أن يُنصت فعليًا للمهمّشات منهنّ ليس لأنهنّ نساء فقط، بل لأنهنّ أيضًا من طبقات فقيرة يعشن في مناطق نائية، قد يكنّ أميات أو لم ينلن تعليمًا كافيًا، ويعملن في ظروف هشّة تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية الاجتماعية.
شهادات من الهامش
فضيلة، شابة في الخامسة والثلاثين من عمرها، وهي مثل مباركة من منطقة ريفية قرب محافظة قفصة. تقول لجيم: "انقطعتُ عن الدراسة بأمر من أبي، وأعمل الآن مع أمي كعاملة فلاحة في أحد الحقول. أعرف بعضًا من حقوقي مثل الحق في العمل الكريم والمساواة في الأجور، لكن لا أستطيع الدفاع عن نفسي. في هذا العمل عادةً ما أتعرض أنا وغيري من النسوة للإهانة وسوء المعاملة. ورغم أن جمعية نسوية زارتنا ذات مرة ووعدتنا بإيجاد حلول لوضعنا، إلا أن شيئًا لم يتغيّر."
مباركة وفضيلة مثل غالبية نساء الريف التونسي، يعشن في مناطق معزولة لا تزال نسبة الأمية فيها مرتفعة بشكل كبير، ومن جانبها تشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء الأميات في تونس تقدّر بحوالي 20 بالمئة في المناطق الريفية مقابل 4 بالمئة فقط في المدن الكبرى1. هذا الواقع يجبرهنّ على العيش في عزلة كبيرة، ويجعلهنّ في مواجهة صعوبات فقط من أجل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم. كما يُقيّد من جهة أخرى قدرة الحراك النسوي على تمثيل أصواتهن، ويجعل تأثيره في أغلب الأحيان محدودًا ولا يترجم فعليًا مطالب هؤلاء النساء المنسيات.
الحراك النسوي ومحدودية الخطاب
تقول أستاذة علم الاجتماع درّة محفوظ: "إن الحركة النسوية في تونس مرّت بثلاث مراحل رئيسة: المرحلة الأولى بدأت مع الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، حين ارتبطت نشأتها بالدولة الوطنية والمكاسب القانونية التي رسّختها مجلة الأحوال الشخصية عام 1956.
ثم جاءت مرحلة الثمانينيات والتسعينيات، حيث ظهرت منظمات نسوية مستقلة تناولت قضايا مثل العنف الأسري والمساواة السياسية.
أما المرحلة الثالثة فقد بدأت بعد ثورة 2011، وشهدت تحوّلات نوعية في الخطاب والأدوات، من بينها اعتماد مقاربات جديدة تحاول تجاوز النظرة إلى النساء باعتبارهنّ فئة موحّدة ومتماسكة."
ذلك ما تؤكده أيضًا الباحثة نبيلة حمزة في أحد محاوراتها الإعلامية2، إذ تقول إنه: مع ثورة 2011 شهدت الحركة النسوية في مرحلتها الثالثة تجديدًا في الخطاب والأدوات، وبرزت فيها مقاربات جديدة مثل النسوية التقاطعية، التي تسعى إلى فهم أشكال القمع المركّبة بما يتجاوز النوع الاجتماعي، لتشمل التمييز الطبقي والعنصري والجنسي، وأشارت في هذا السياق إلى أن القيم الأساسية للنضال النسوي مثل مقاومة العنف والتمييز والدفاع عن الحقوق، تبقى قواسم مشتركة بين مختلف الأجيال رغم التباين في الأساليب.
غير أن قراءة الناشطة النسوية مريم بن أحمد للخطاب النسوي التونسي تختلف عن قراءة نبيلة حمزة في بعض النقاط، إذ تصرّح بن أحمد لجيم أن الخطاب النسوي اهتم في البداية بأولويات طبقات معيّنة، وكان يركّز على تحقيق حقوق قانونية مثل الحريات الشخصية والحق في الميراث والتمكين السياسي للنساء. وفي كثير من الفترات تغافل هذا الخطاب عن التحديات اليومية التي تواجهها النساء في الأرياف، "حيث لا ينلن على التقدير الكافي لجهودهن الاقتصادية والاجتماعية، ويتم تجاهل مطالبهن في الحصول على أبسط حقوقهن".
وتوضح بن أحمد أن الخطاب النسوي في بداياته تجاهل قضايا العمل الريفي والظروف الاقتصادية للنساء في الأرياف، حيث تعيش كثير من النساء في فقر مدقع وتعمل في بيئات غير مهيّأة، دون أن تحصل على الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية.
ومع تغيّر بنية المجتمع التونسي، وظهور صورة المرأة الريفية في الإعلام، أقرّت ناشطات حقوقيات بوجود تباين حقيقي في مطالب النساء التونسيات، إذ تختلف أولويات النساء القاطنات في المناطق الحضرية عن أولويات النساء في الأرياف المعزولة.
هذا الوعي دفع بالخطاب النسوي إلى التجديد، انطلاقًا من إيمان الناشطات بأن "التعامل مع هذا التفاوت يتطلّب نظرة نسوية تتجاوز الإطار التقليدي، وتعترف بالاختلافات بين نساء المدن ونساء الريف".
وهنا تبرز أهمية النظر إلى قضايا النساء من زاوية أكثر تعقيدًا، تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الطبقية والجغرافية والتعليمية والاقتصادية.
ومن جانبها تعد النسوية التقاطعية مقاربة تتيح فهمًا أعمق لتجربة مباركة وأخواتها، باعتبارها امرأة ريفية أميّة وفقيرة، فيما تعمل في الأرض ولا تحظى بأي حماية اجتماعية.
تداخل أشكال التمييز
في حقيقة الأمر لا تُعدّ النسوية التقاطعية مقاربة جديدة، بل هي منهج فكري ونقدي أسسته نسويات من الجنوب العالمي، وعلى رأسهنّ نساء سوداوات منذ ثمانينيات القرن الماضي، كأداة لفهم أشكال القمع المركّبة التي تتجاوز النوع الاجتماعي لتشمل الطبقة والعرق والانتماء الجغرافي.
واليوم تعتمد العديد من الحركات النسوية في دول الجنوب - ومن بينها حركات نسوية عربية - هذه المقاربة لفهم واقع النساء في الهامش، وتفكيك بنية التمييز المركّب الذي يتقاطع فيه النوع الاجتماعي مع الفقر والأمية والموقع الجغرافي وغيرها من عوامل الإقصاء.
وبالعودة إلى مصطلح "تقاطعية"، فقد صاغته كيمبرلي كرينشو (1959)، المحامية والناشطة النسوية من أصول إفريقية، لأول مرة في مقالتها المؤثرة الصادرة سنة 1989 بعنوان "إلغاء تهميش تقاطع العرق والجنس" والتي قدمت فيها نقدًا نسويًا أسود لعقيدة مناهضة التمييز والنظرية النسوية والممارسات السياسية المناهضة للعنصرية"3.
ركّزت كرينشو في مقالتها على التمييز المزدوج الذي تتعرض له النساء السود في الولايات المتحدة، حيث يُقصين من التحليلات النسوية التي تركز على النساء البيض، وكذلك من التحليلات المناهضة للعنصرية الخاصة بالرجال السود. وقد أوضحت في مقالتها أن: "التجربة التقاطعية تفوق مجموع العنصرية العرقية والعنصرية الجندرية، وأي تحليل لا يأخذ التقاطعية بعين الاعتبار لا يمكنه أن يوضّح الكيفية التي يُخضع بها النظام النساء السود"4.
ومع تطوّر البحوث، امتدّ تطبيق هذا المنهج إلى مجالات أكاديمية متعدّدة مثل علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس. والذي أسهم في نشوء ما يُعرف اليوم بـ"الاقتصاد النسوي التقاطعي"، الذي يُعزّز فهم التمييز الطبقي والجندري والعرقي من خلال مناظير متعدّدة.
وبما أن هذا المنهج يقوم على مبدأ التداخل، ويُقِرّ بالتعدّد ويرفض المقاربات الأحادية، فإن دوره لا يقتصر على تحليل واقع النساء، بل يسعى إلى إحداث تغيير ملموس من خلال تفكيك الأنظمة الاجتماعية السائدة، وفتح المجال أمام بناء ممارسات معرفية جديدة تُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
علاقات القوّة
بالنسبة إلى مباركة وفضيلة خصوصًا، والفلاحات الريفيات عمومًا، لا تكمن أهمية طرح المقاربة التقاطعية في كونها أداة لفهم الواقع بهدف تغييره؛ وفي مقالنا هذا لا يعد استحضار هذه المقاربة من باب "ترف المفاهيم"، بل لأنه يتيح لنا قراءة معاناة نساء مثل مباركة وفضيلة بوصفها نتيجة تراكم عوامل متعددّة من التهميش، بداية من كونهن نساء ومن طبقة فقيرة، ونهاية بكونهن يقطنّ في مناطق داخلية مهمّشة. وقد تسمح هذه القراءة المتعدّدة الأبعاد بإعادة النظر في السياسات العامة، وفي أولويات الحراك النسوي نفسه، الذي غالبًا ما يغفل قضايا النساء في الأرياف.
فمن خلال هذا المنظور، يمكن للمقاربة التقاطعية أن تساهم في بلورة حلول أكثر عدالة وإنصافًا، مثل: توفير آليات حماية قانونية للعمل الزراعي وتحسين خدمات النقل، وكذلك إدماج نساء الأرياف في السياسات التعليمية والصحية وإعادة الاعتراف بجهودهن الاقتصادية.
هذه المقاربة تُثير أسئلة مُلحّة مثل: لماذا لا يُعترف بعمل الفلّاحات؟ ولماذا تبقى أصواتهنّ غير مسموعة في صياغة السياسات؟ ولماذا لا تُدرج مطالبهنّ ضمن أولويات النضال النسوي الوطني؟
النسوية التقاطعية كما عرّفتها كيمبرلي كرينشو، هي "طريقة لفهم علاقات القوة الاجتماعية ومواجهتها، وكشف محدودية التمثيلات المهيمنة التي تُقصي الفئات المهمشة"5. وفي هذا السياق لا يمكن اختزال معاناة الفلاحات بمتغيّر واحد، إذ إنها ناتجة عن تفاعل معقّد بين البنى المجتمعية والسياسية والدينية والاقتصادية.
ولفهم هذه التفاعلات، يمكن تصوّر أربعة متغيرات رئيسة تؤثّر في وضعية الفلاحات وهي: العائلة والمجتمع والدين والاقتصاد. وغالبًا ما تتداخل هذه المتغيرات لإعادة إنتاج علاقات الهيمنة، مما يؤدي إلى تهميش مضاعف.
فمثلًا امرأة من منطقة داخلية فقيرة، لا تملك سندًا عائليًا أو دعمًا سياسيًا، تعاني من إقصاء متعدّد الأبعاد يضعها في أدنى مراتب السلطة الاجتماعية.
وفي السياق التونسي، تتغيّر آليات القوة بحسب وزن هذه المتغيرات، ففي العائلة غالبًا ما يكون الأب أو الأخ هو "ربّ الأسرة" من منطلقٍ ذكوري، وهو من يتحكّم بالموارد الاقتصادية ويتصرّف بها، مما يجعل المرأة دومًا رهينة قرارات الأب أو الأخ، كما هو الحال بالنسبة إلى فضيلة التي امتثلت لقرار والدها حين طلب منها الانقطاع عن الدراسة والعمل في الحقول إلى جانب والدتها.
وهي الحقيقة التي أشارت إليها غيردا ليرنر حين قالت: "خضوع المرأة للسلطة الذكورية ارتبط دومًا بمنطق الحماية الأبوية، ما جعلها حبيسة حالة طفولية دائمة6".
بالانتقال إلى دور المجتمع، فإننا نجده هو من يسنّ جملة من العادات والتقاليد التي تحدّ من حرية المرأة وتقيّد خياراتها. وفي ما يخصّ الدين، فإن بعض الأطراف توظّفه لإضفاء شرعية على التفاوتات الجندرية وتكريس التمييز بين النساء والرجال.
وباستقراء هذه المعطيات، نرى أن المقاربة التقاطعية توضح أن واقع الفلاحات التونسيات هو نتيجة تفاعل معقّد بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في نشاط الحراك النسوي، وتجديد خطابه بما يأخذ هذا التشابك الفريد من التمييز بعين الاعتبار.
فإذا نظرنا إلى الواقع التونسي، وتحديدًا عبر قصة "مباركة"، المرأة الريفية من سيدي بوزيد، نُدرك أن النسوية التقاطعية لا تجد تجسيدًا حقيقيًا في خطاب الحركات النسوية التونسية.
قصة مباركة هي مثال حيّ على التحديات التي تواجه النساء في المناطق الداخلية، حيث يعانين من التهميش على مختلف الأصعدة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. في المقابل تبدو الحركات النسوية المجتمعة في النزل الفاخرة مفتقرة إلى التمثيل الحقيقي للواقع، وإن تطرّقت إليه أحيانًا فإن ما تفعله لا يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات مجتمعة ضمن مقاربة تقاطعية شاملة.
بهذا الشأن تقول درّة محفوظ لجيم: "إن التقاطعية لا يجب أن تظلّ أداة تحليل جامدة أو حكرًا على الخطاب الأكاديمي، بل يمكن أن تتحوّل إلى وسيلة فعالة لفهم واقع النساء الريفيات وبناء سياسات تدخل أكثر عدالة وشمولاً". مضيفة أنه لم يعد كافياً اليوم التحدّث عن معاناة الفلاحات من التهميش، بل علينا أن نسأل: كيف نعيد توزيع الموارد؟ وكيف نُدرج أصوات النساء من الهامش في قلب النقاش العام؟.
وتشير محفوظ إلى أن بداية وجود مبادرات نسوية مجتمعية بدأت في هذا الاتجاه، لكنّها لا تزال بحاجة إلى دعم مؤسسي واستراتيجي حتى لا تبقى معزولة أو رمزية، بل تُحدث أثرًا فعليًا في بنية الوعي والسياسات.
- 1
المعهد الوطني للإحصاء، المؤشرات الاجتماعية في المناطق الريفية، 2021.
- 2
نبيلة حمزة، الحركة النسوية في تونس: تعددية الرؤى والمقاربات، مجلة دراسات المرأة، 2020.
- 3
إلغاء تهميش تقاطع العرق والجنس: نقد نسوي أسود لعقيدة مناهضة التمييز والنظرية النسوية، والممارسات السياسية المناهضة للعنصرية" (1989)، موقع الهامش: https://al-hamish.net/7517.
- 4
كيمبرلي كرينشو، إلغاء تهميش تقاطع العرق والجنس...، ibid.
- 5
كيمبرلي كرينشو، إلغاء تهميش تقاطع العرق والجنس.
- 6
غيردا ليرنر، نشأة النظام الأبوي، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2005، ص 422.
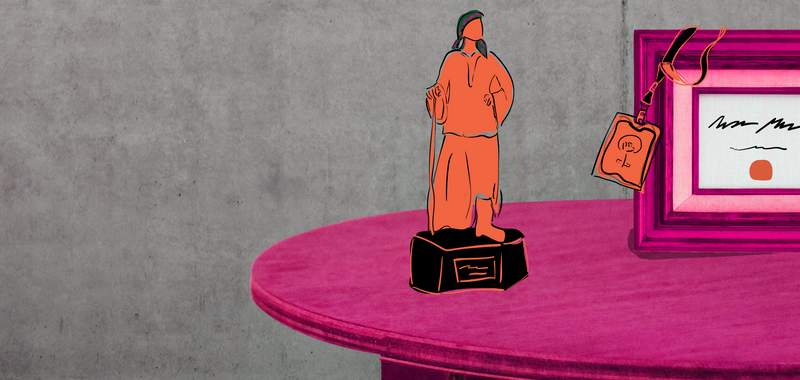
إضافة تعليق جديد